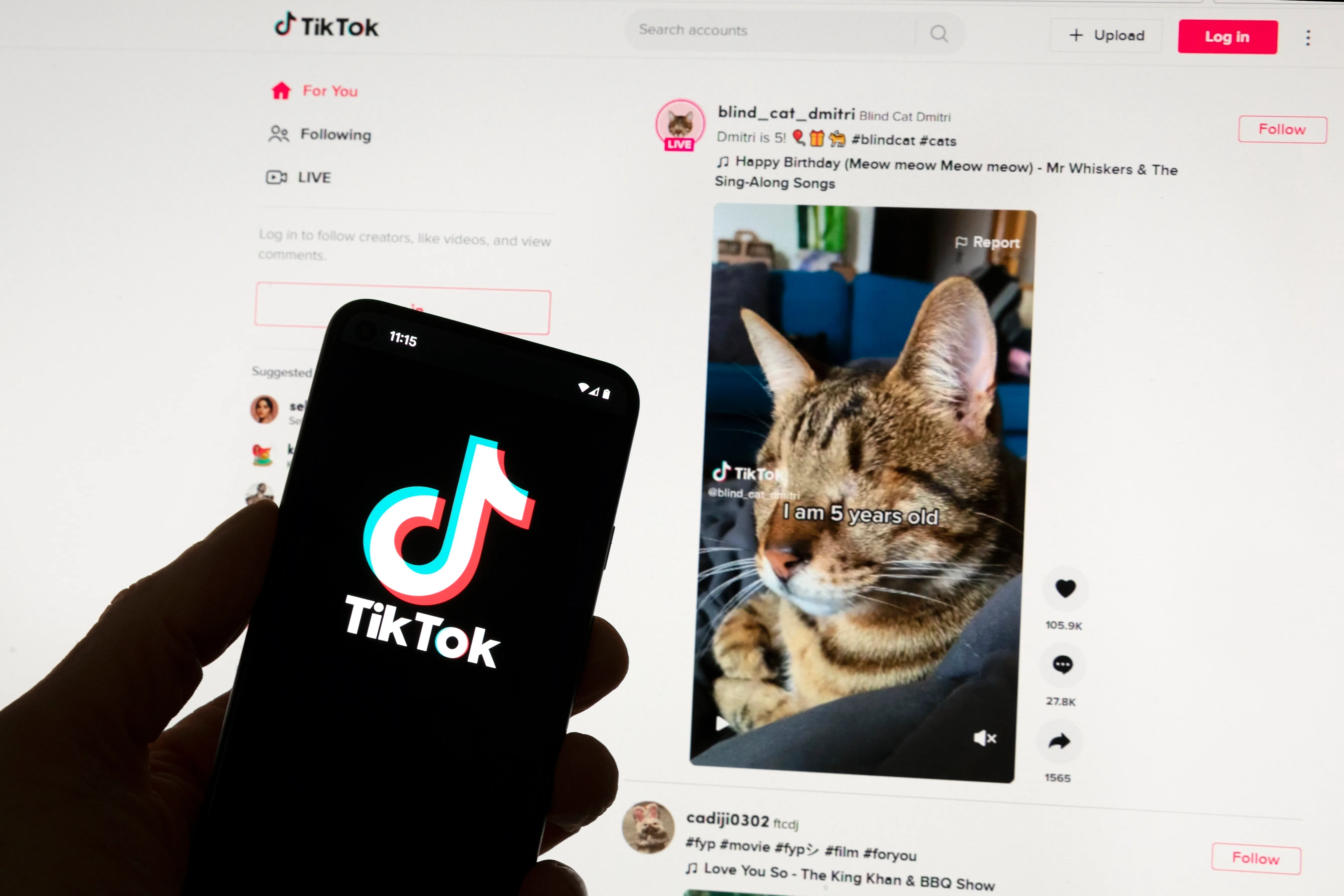في قلب القدس العتيقة، حيث تتوقف عقارب الزمن، تنبعث رائحة الهيل والقرفة من قدر نحاسي، معلنة لحظة "القلب"، تلك اللحظة التي تتجاوز كونها تقليدًا منزليًا لتصبح جزءًا من الذاكرة الفلسطينية. تروي الذاكرة الجمعية، كما وثقتها السير الشعبية، أن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي سأل بذهول: "ما هذه الأكلة المقلوبة؟"، حين قدمها له المقدسيون احتفاء بفتح بيت المقدس عام 1187م، ليتحول اسمها من "الباذنجانية" إلى "المقلوبة" التي قلبت موازين الطهي والسياسة معا، بحسب ما ذكرته المرويات الشفوية الموثقة في مركز التراث الشعبي الفلسطيني.
هذه الأكلة لم تكتف بمكانتها على الموائد، بل خلدت بشموخ في كتب التاريخ، ففي القرن العاشر الميلادي، ذكرها ابن سيار الوراق في كتابه الشهير "الطبيخ"، واصفا تلاحم اللحم مع الباذنجان المقلي في تناغم لذيذ تحت مسمى "الباذنجانية"، حيث كان الباذنجان يقلى ويرص في القاع ليغطى باللحم والأرز المتبل، قبل أن يعرف العالم مفهوم "التراص الطبقي" المعاصر بفروقه الحالية.
في رحلتها الأولى في عالم الطبخ، اعتمدت المقلوبة (الباذنجانية) على لحم الضأن السمين والباذنجان الذي كان يطلق عليه "سيد الخضار"، وكان البرغل هو الرفيق الأول للخضار واللحم قبل أن ينسحب تدريجيا أمام سطوة الأرز الذي دخل المنطقة عبر طرق التجارة ليمنح المقلوبة قوامها الحالي.
المقلوبة بين الماضي والحاضر
ومع مرور القرون، وتحديدا في ريف فلسطين، خلعت المقلوبة ثوبها المخملي لترتدي أثوابا قروية، فدخلت "الزهرة" أو القرنبيط في تكوينها تماشيا مع مواسم الأرض الزراعية، وتحول اللحم إلى دجاج ليناسب النمط الاقتصادي والمعيشي الحديث، حيث أصبح الدجاج هو "البطل الشعبي" الذي يتشرب نكهة الباذنجان المكرمل دون أن يطغى عليها كما يفعل اللحم الأحمر.
ووفق دراسات المتحف الفلسطيني، تؤكد السجلات التاريخية والمخطوطات القديمة أن جوهر "المقلوبة" يرتبط ارتباطا عضويا بزيت الزيتون والباذنجان الفلسطيني، وهو ما وثقته دراسات أنثروبولوجية تناولت تطور المطابخ الشامية باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية.
وتتجلى جغرافيا المذاق الفلسطيني في التمييز الدقيق بين المقلوبة وشقيقتها "القدرة الخليلية"؛ فبينما تطهى المقلوبة في قدور الالمنيوم بالمنازل وتزدحم بالخضار المقلية والبهارات الصفراء، تظل القدرة الخليلية هي "ملكة الولائم" التي ترفض الباذنجان والزهرة تماما.
القدرة الخليلية والمقلوبة: نكهات متفردة
ترسم الكاتبتان ليلى الحداد وماغي مصلح في كتابهما "المطبخ الغزي: رحلة طهي فلسطينية"، فاصلا دقيقا يتجاوز المكونات ليصل إلى روح المكان، فبينما المقلوبة هي ابنة المنازل والقدور المفتوحة، تظل القدرة طبقا غنيا وقوي المذاق، يستمد اسمه من الوعاء النحاسي أو الفخاري الذي يحتضنه.
وعلى نقيض المقلوبة التي ترتكز في جوهرها على هندسة "طبقات الخضار" المقلية، تذهب القدرة نحو تكثيف النكهة عبر اللحم والأرز المتبل بعناية فائقة، وتكمن الميزة الأساسية التي يبرزها الكتاب في "استخدام رؤوس الثوم الكاملة التي تطبخ داخل الأرز لتصبح طرية كالزبدة، مع الحمص المسلوق والسمن البلدي".
هذا التفرد لا يتوقف عند المكونات، بل يمتد لأسلوب "الخبيز" بدلا من "القلي"؛ حيث تقتضي التقاليد ارسال فخارات لتنضج ببطء داخل أفران الحطب العامة، بينما تعد المقلوبة رمزا للحياة اليومية الفلسطينية.
المقلوبة كأداة للمقاومة الثقافية
وتعتبر الكاتبة والشيف الفلسطينية جودي القلا أن المقلوبة بمثابة لوحة جغرافية، إذ تقول في كتابها "في القدس، نتمسك بالتقاليد حيث يطغى الباذنجان واللحم الذي ينضج حتى يذوب، مع مسحة الكركم التي تمنح الأرز لونه الذهبي، لكن عندما تتجه شمالا نحو الجليل، تجد الزهرة (القرنبيط) تأخذ مكان الصدارة، وفي غزة يضيفون لمستهم الخاصة من الحرارة والتوابل القوية، المقلوبة ليست مجرد طعام، إنها استعراض للهوية؛ لحظة قلب القدر هي اللحظة التي يتوقف فيها الجميع عن الكلام بانتظار الكشف عن الطبقات المرصوصة بعناية، إنها لحظة فخر وطني تطبخ في كل بيت".
في السنوات الأخيرة، تجاوزت المقلوبة حدود المطبخ لتصبح أداة للمقاومة الثقافية، فمشهد "المرابطات" وهن يقلبن قدور المقلوبة في ساحات المسجد الأقصى، بات رسالة رمزية تعبر عن "قلب موازين القوى" والتمسك بالأرض والهوية أمام محاولات الطمس الثقافي.
اللحوم: لحم الضأن (الغنم) بالعظم، أو الدجاج.
مكونات المقلوبة
الخضار: الباذنجان (الأساس)، الزهرة (القرنبيط)، والبطاطس.
الأرز: يفضل مزيج بين الأرز متوسط الحبة (المصري) والأرز طويل الحبة.
البهارات: بهار المقلوبة الفلسطيني (قرفة، هيل، فلفل أسود، عصفر أو كركم للون الأصفر، جوزة الطيب).
طريقة تحضير المقلوبة
سلق اللحم: يسلق اللحم مع المطيبات حتى ينضج تماما.
قلي الخضار: يقشر الباذنجان ويقطع ويقلى (أو يشوى حديثا لتقليل الزيت)، وكذلك البطاطس والزهرة.
ترتيب الطبقات: في قاع القدر، يوضع اللحم أولا، ثم ترص الخضار المقلية فوقه وبجانبه، ثم يغطى بالأرز المتبل.
الكنافة النابلسية: حكاية حلوة
تشير مصادر التراث الغذائي إلى أن الكنافة ظهرت في سياق البلاط الأموي، مع اختلاف الروايات حول المكان والشخصية المرتبطة ببداياتها الأولى، وتنسب إحدى أقدم الروايات إلى دمشق، حيث قيل إن الكنافة صنعت خصيصا لتكون طعام سحور للخليفة سليمان بن عبد الملك، فيما تذهب روايات أخرى إلى ربطها بالخليفة معاوية بن أبي سفيان، بوصفها وجبة تهدف إلى تخفيف الإحساس بالجوع خلال ساعات الصيام، وفي تلك المرحلة، كانت الكنافة تعتمد في تكوينها على خيوط العجين المصبوبة فوق صفائح نحاسية، وتحلى بالسكر أو العسل.
ويورد شهاب الدين النويري في كتابه "نهاية الأرب في فنون الأدب" إشارات إلى الكنافة في سياق ما يعرف بـ"أدب الطعام"، مقدما إياها بوصفها واحدة من أرقى الحلويات التي زينت موائد الخلفاء في العصر الأموي، ولا سيما في القصور المروانية، ويصف النويري الإقبال عليها وتحولها من طبق خاص بالنخبة الحاكمة إلى حلوى شائعة في الحياة الاجتماعية لاحقا.
أما رواية معاوية بن أبي سفيان على وجه الخصوص، فقد نقلها جلال الدين السيوطي في رسالته الخاصة عن الكنافة، اعتمادا على ما ورد في كتاب "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار".
الكنافة تتحول إلى رمز شعبي في نابلس
ووفقا لهذه الرواية، كان معاوية يشكو من جوع شديد أثناء نهار رمضان، فلجأ إلى طبيبه الخاص محمد بن آثال، الذي ابتكر له طبقا يجمع بين العجين المطهو بالسمن والقطر، ليكون وجبة سحور ثقيلة تبطئ عملية الهضم وتوفر طاقة ممتدة، وهو ما أدى إلى شيوع تسمية "كنافة معاوية" في عدد من المصادر التاريخية.
غير أن التحول الجوهري في تاريخ الكنافة، كما تشير إليه المصادر نفسها، ارتبط بانتقالها إلى مدينة نابلس، حيث أدخل الصناع الفلسطينيون الجبن الأبيض المحلي (الجبن النابلسي) بديلا عن الحشوات التقليدية من المكسرات أو القشطة، هذا التحول نقل الكنافة من كونها طبقا نخبويا مرتبطا بالقصور إلى رمز شعبي راسخ، التصق بهوية المدينة الكنعانية، ومنحها خصوصيتها التي عرفت بها لاحقا باسم "الكنافة النابلسية".
وفي كتاب "منهل اللطائف في الكنافة والقطايف" للسيوطي، يذكر أبياتا من الشعر تظهر كيف انتقلت هذه الأكلة من كونها "وصفة طبية" لمعاوية إلى غرام شعبي وأدبي، فيقول الشاعر:
المكونات الأساسية للكنافة النابلسية
عجينة الكنافة: ناعمة (الأقرب للأصل) أو خشنة حسب الرغبة.
الجبن النابلسي: جبن غنمي طازج، ينقع ويغير ماؤه حتى تزول الملوحة تماما.
السمن البلدي: حيواني أصيل لإبراز النكهة التقليدية.
خطوات التحضير النابلسية
فرك العجينة: تفرك الكنافة بالسمن المذاب حتى تتشربه بالكامل، مع إمكانية إضافة صبغة الكنافة للون التقليدي.
رص الصينية: تدهن الصينية بالسمن، وتفرد العجينة وتضغط جيدا حتى تتماسك.
إضافة الجبن: يصفى الجبن ويوزع فوق العجينة مع ترك هامش عن الحواف.
المفتول: حكاية طعام الأرض
يعد المفتول من أقدم الأطباق الفلسطينية التقليدية، ويرتبط بالمطبخ القروي في فلسطين، حيث كانت النساء يصنعنه يدويا من البرغل والطحين عبر عملية لف طويلة تحتاج إلى وقت وصبر، ما جعله طبقا جماعيا مرتبطا بالتعاون بين نساء القرية.
ورغم تشابهه مع الكسكس في الشكل، فإن المفتول يتميز عنه بكونه يدوي الصنع بالكامل وبحبيبات أكبر، كما يعتمد على مكونات محلية مثل زيت الزيتون، الحمص، الدجاج البلدي أو اللحم، ويطهى بمرق غني بالتوابل الفلسطينية.
تاريخيا، كان المفتول يحضر في المناسبات الكبيرة وشهر رمضان، نظرا لقيمته الغذائية العالية وقدرته على إشباع عدد كبير من الناس، مما جعله طبقا مثاليا للإفطار الجماعي، ومع مرور الوقت، أصبح المفتول رمزا للمائدة الفلسطينية التقليدية وواحدًا من الأطباق التي تعكس علاقة المطبخ الفلسطيني بالأرض والعمل اليدوي.
المفتول: عملية حب وصبر
وتصف ريما قسيس المفتول في كتاب "المائدة الفلسطينية (The Palestinian Table)" فصل "الأطباق الرئيسية"، بأنه "عملية حب وصبر". وتذكر قسيس أن المفتول هو النسخة الفلسطينية من الكسكس، لكنه يختلف جذريا في الحجم والنكهة، وتقول: "بينما يصنع الكسكس من السميد، يصنع المفتول من البرغل المغطى بطبقات من طحين القمح الكامل.
وتربط الكاتبة بين المفتول وبين قرى الجليل، وتوضح أن سر المفتول الفلسطيني يكمن في "الدقة" (خليط البصل والكمون وعين الجرادة) التي توضع داخل حبات المفتول أثناء تبخيره، وهو ما لا يوجد في أي نوع كسكس آخر.
بينما تقول الكاتبة والشيف جودي كالا في كتابها "فلسطين في طبق" (Palestine on a Plate) إن المفتول ليس مجرد طعام، بل هو "حدث اجتماعي"؛ حيث كانت النساء يجتمعن لإنتاج كميات كبيرة تكفي للقرية أو لتخزينها (المونة)، وتذكر أن رائحة اليقطين والحمص والبصل التي ترافق المرق هي "رائحة البيت الفلسطيني في الشتاء".
المفتول: طعام البركة
أما الموسوعة الفلسطينية (قسم المأكولات الشعبية) فتوثق المفتول كجزء من الأمن الغذائي القروي، فهو سيد المونة الشتوية؛ تعده القرويات في أواخر الصيف، ويجفف تحت الشمس فوق أقمشة بيضاء نظيفة، ثم يخزن في أكياس من القماش (خيش) ليكون الزاد الأساسي في أيام المطر والثلوج. وتشير الموسوعة إلى أن المفتول يسمى "طعام البركة" لأنه يزداد حجمه عند الطبخ ويشبع أعدادا كبيرة من الناس بمكونات بسيطة من نتاج الأرض.
وفي كتابها "الحياة المنزلية في فلسطين (Domestic Life in Palestine)"، تصف ماري روجرز مشاهدا من بيوت القدس والجليل طبقا يقدم في المناسبات يتكون من "كرات عجين صغيرة مطبوخة فوق بخار اللحم، وتقدم مع مرق غليظ مليء بالبصل الأصفر والحمص والقرع"، كانت تندهش من كيفية تحويل الطحين إلى هذه الكرات المتساوية يدويا، واصفة إياها بأنها وجبة "مغذية جدا ومشبعة للشعوب التي تعمل في الزراعة".
- حلة "الفتل" (يدويا)
الأساس: رشي القليل من الماء على البرغل الناعم في وعاء واسع.
التكوير: أضيفي الطحين (أبيض وأسمر) تدريجيا مع تحريك يدك بحركة دائرية مستمرة حتى تتغلف حبات البرغل وتتحول لكرات صغيرة.
المغربلة: استخدمي الغربال لتوحيد حجم الحبات والتخلص من الطحين الزائد. - مرحلة "التهبيل" (الطهي بالبخار)
القدر: يوضع المفتول في قدر مثقب (مفتولية) فوق قدر به مرق يغلي.
الدقة: في منتصف المفتول، ضعي خلطة (بصل مفروم، كمون، عين جرادة، ملح) لتنضج مع البخار وتفوح رائحتها داخل الحبات.
النضج: يترك على البخار لمدة 45-60 دقيقة، ثم يرفع ويفرك بـ السمن البلدي أو زيت الزيتون. - التقديم (اليخنة)
يسقى بمرق الدجاج أو اللحم الغني بـ اليقطين (القرع)، الحمص المسلوق، الكثير من البصل، والجزر.
تظل هذه الأطباق شاهدة على تنوع المطبخ الفلسطيني وارتباطه الوثيق بخيرات الأرض ومواسمها، فهي ليست مجرد وجبات، بل هي موروث اجتماعي يجمع العائلة على مائدة واحدة غنية بالحكايا والنكهات الأصيلة.